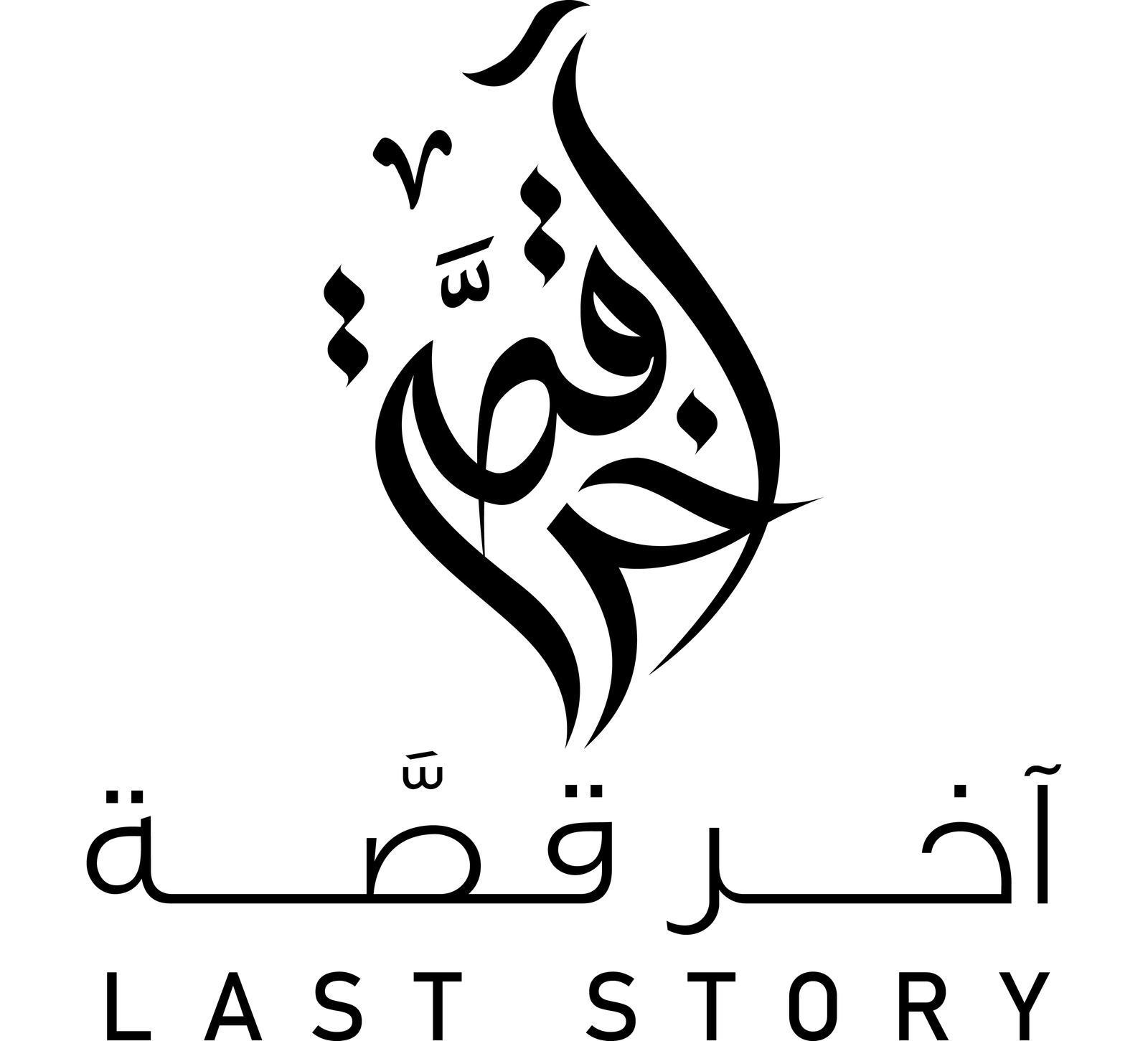بقلم: فداء الحسنات
على شارع صلاح الدين جنوباً، على امتداد البصر، هناك حزنٌ مبعثرٌ لا تخطئه العين.
منذ أن قرر السائق أن يسلك هذا الطريق تجنّباً للازدحام الذي يبتلع الوقت، وأنا أشعر بصخرةٍ ثقيلةٍ تسكن حلقي.
أين البيوت والدكاكين؟ أين محطات البنزين؟ ولمَ الطريقُ فارغٌ تماماً هكذا؟
شعرتُ بالخوف حين توقفت الخيام عن الاصطفاف في منتصف الطريق.
صرنا على الحافة تماماً.
أردد في قلبي: «يا حفيظ»، وأفكّر في شكل الخبر الذي ستقوله الصحف عن موتنا.
لقد شعرتُ بوحشةِ كلّ البيوتِ المتروكة، تلك التي تواجه هذا الخوفَ وحدها كلَّ يوم.
أين ناسها اليوم؟
هل مازالت تحتفظُ بصوتِ قرقعة الملاعق على طنجرة المقلوبة؟
من أطفأ جميع الأنوار؟
وكيف تؤنس نفسها في هذا الليل الطويل؟
لقد امتلأتُ بكلّ أسباب الحزن.
وحين وصلتُ إلى مقرّ عملي، لم أستطع نفض هذا الغبار عن جسدي، ولا عن رأسي.
كان الغبارُ العابر من بيتٍ مهدومٍ يلسع عينيّ.
اليوم أنا حزينةٌ بشكلٍ مختلف.
تذكّرتُ حلماً كان يزورني بين الحين والآخر في السنوات الماضية.
اليوم، كانت كلّ المشاهد صوراً حقيقيةً رأيتُها سابقاً في نومي، مخزّنةً في «الثقب الأسود» في آخر دماغي، كما تقول صديقتي.
لكنها اليوم وجدت طريقها لتصير دهشةً حزينةً تُخرسني، وتكبّلني، وتربطني بصخرةٍ كبيرة، ثم تلقي بي في قاع المحيط المعتم.
أُخرج يدي من النافذة، أُصافح البيوتَ والشوارعَ والأسفلت، وأتذكّر يوماً كانت السيارة تسير فيه مسرعةً على طريق صلاح الدين حتى تصل رفح، وتعود بشكلٍ عاديٍّ جداً، وكأنها أكثر الأشياء العادية حدوثاً.
وأحاول التوقف عند هذا الحد.
هذا الهواءُ الرطبُ لي.