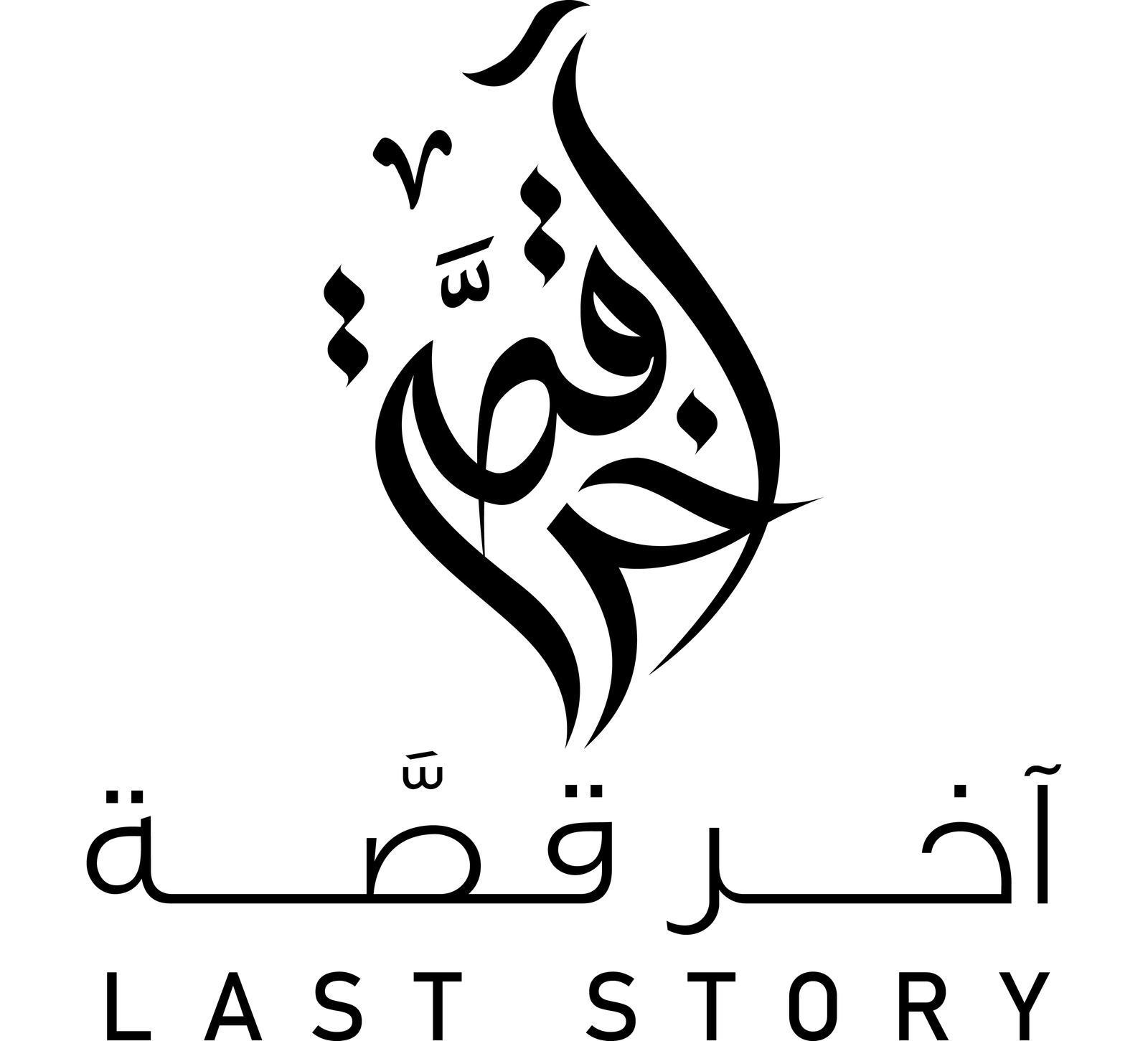كان هناك دومًا صندوقٌ خشبي صغير على مكتب المحامية والناشطة النسوية الرائدة إصلاح حسنية. كان يلمع بطبقةٍ من الغبار، ويحمل في جوفه دعوى قضائية من عام 1979، ولمسة من الفلفل الحار المجفف، ورخصة محاماة شرعية مزورة باسم رجل.
لم يكن ذلك الصندوق مجرد وعاء لأوراقها؛ بل كان مختبرها المصغر، ومخزن أدواتها المبدأي. كان يجسّد في حيّز مادي، رؤيتها للقانون: كسلاح، وكعائق، وكأداة تشريح للمجتمع. كأول امرأة تفتتح مكتب محاماة في غزة، كانت تعلم أن الصندوق يحمل أكثر من محتوياته؛ فهو يحمل خريطة طريقها، والصوت الذي سيكسر، لاحقًا، صمت قاعة المحكمة الذكورية.
"الدفاع ليس نقاشًا، إنه هندسة معمارية".
إصلاح حسنية، لزميلتها زينب الغنيمي، 1998.
في عام 1978، لم تفتح حسنية "مكتب محاماة". بل صنعت فجوة في سياج مهني محكم. كان الذكور حارسين له. بدأت باستيراد القضايا: مستوردات غير مرغوب فيهن من النظام: سجناء من سجن نفحة، نساء مُسكتات في قضايا طلاق، رجال محتجزون بلا تهم. لم تكن تمثلهم؛ كانت تجرب عليهم فرضية: هل يمكن تحويل قاعة المحكمة إلى موقع تحدي منهجي؟
تعاونت مع محامين إسرائيليين، مثل فيليسيا لانجر، ليس كشركاء، بل كمرايا. كانت تدرس انعكاس القانون على نفسه عبر الاحتلال. كانت ترفض الأجر، إذ ترى أنّ المال يلوث نقاء التجربة، ويحوّل القضية إلى خدمة. فهي لم تكن تقدم خدمة؛ كانت تبني نموذجًا أوليًا.
وبحلول عام 2002، حصلت على الترخيص الشرعي. لم يكن هذا "إنجازًا" بل كان "إثباتًا للثغرة". كانت قد اكتشفت أنّ أقسى الجدران – المنظومة الشرعية – يمكن اختراقها بالضبط بنفس الأدوات التي بُنيت بها. في قاعة المحكمة الشرعية، حيث كانت أحيانًا المرأة الوحيدة، لم تكن تدافع عن موكلها. كانت تختبر سُمك الصمت المحيط بهما. الخوف من النبذ، الخوف من العنف، الخوف من "الجرأة الزائدة"، كانت تدرج هذه المخاوف كأدلة في ملف القضية، أكثر من نصوص القانون نفسه.
"المحاميات لا يُنظر إليهن كأجزاء أصلية في قاعة المحكمة. كأنهن زوائد لا تتبع التصميم الأصلي".
من مقابلة صحفية مع حسنية، 2011.
النقابة بالنسبة لها كانت آلة كبيرة، مصممة لتداول النفوذ بين الذكور. في عام 2002، ترشحت حسنية وفازت. لم يكن هذا "تمثيلًا للمرأة". كان عملية قرصنة ناعمة، فعند دخولها المجلس، لم تحاول "الإصلاح". حاولت إعادة تشغيل النظام من داخله. دفعت باتجاه مساءلة، معايير، تفعيل لجان خاملة، إذ أرادت معرفة: ما الذي يمكن أن ينهار داخل النظام إذا ما أجبر على محاسبة نفسه؟
عندما دخلت مرحلة الانقسام الفلسطيني عام 2006، وشهدت مؤسسات المجتمع المدني حالة من التصدّع المؤسسي، لم تكن الأزمة بالنسبة لحسنية سياسيةً فحسب؛ بل كانت بالأساس أزمة في "نظام التشغيل" المؤسسي القائم. وكاستجابة مؤسسية صرفة، قامت حسنية مع زملائها بإنشاء "مركز المرأة للاستشارات والحماية القانونية" كـ "منصة مستقلة".
لم يكن المركز مجرد مساحة بديلة؛ كان خادمًا بديلاً، مُصممًا للعمل في ظل ظروف انهيار البنية التحتية للحوكمة. كان يقدم الخدمات القانونية، نعم، ولكن الأهم: كان يُشغّل برنامجًا تدريبيًا عملياتيًا – ما سمّته "فقه النسوية" – الذي حوّل النظرية النسوية من خطاب إلى دليل تشغيلي لقراءة القانون، وتطبيقه، وتجاوز قيوده في واقع متشظٍّ.
"طالما هناك جدران، سأعيش فيه".
آخر تصريح معروف لحسنية، أغسطس/آب 2025.
منزلها في غزة لم يكن مسكنًا. كان موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا في صراعها الشخصي ضدّ النزوح خلال الحرب التي اندّلعت في أكتوبر 2023، فالقصف الإسرائيلي دمّر جزءًا منه. نُصبت خيمة جنوب القطاع. وحينها عُرض عليها مأوى بديل لكنّها رفضت وآثرت البقاء في خيمة إلى حين السماح بالعودة للبيت.
الاستعاضة عن المنزل بخيمة نزوح أو مأوى طارئ هي انتهاك صارخ لمبدأ هندستها الوجودية. إذ صممت حياتها كسلسلة من الاختيارات الثابتة في وجه قوى تحاول إزاحتها بشكل دائم. العودة إلى الأنقاض، والعيش فيها، كان الفصل الأخير من تجربتها: كيف تُواجه الإبادة ككائن بشري دون أن توافق على أن تُزال من مكانك؟
في بيتها المُدمَّر في غزة، وسط الركام والجدران الواقفة جزئياً، عاشت إصلاح حسنية أيامها الأخيرة. في تلك الغرفة الواحدة التي جُهد لترميمها، ومع وجود ممرضة تُقدّم لها العناية، واجهت المعادلة المستحيلة للحصار الذي فرضه الاحتلال خلال شهور المجاعة حيث مُنع إدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة، فكانت المعادلة: الجدران قد تُسند، لكن الحصار يقطع الأوكسجين الحيوي - الغذاء والدواء.
وسط هذه الظروف، تهاوى نظام جسدها الحيوي، الذي صمد لعقود أمام تحديات المجتمع والسياسة والقانون، استسلم أخيراً لنُدرة الإنسولين وحبات الدواء. تدهورت صحتها. سقطت في غيبوبة. لاحقًا، أُعلن عن وفاتها في إحدى مستشفيات مدينة غزة. لكن القرار الجوهري - قرار رفض الهزيمة والتمسك بالحياة على الركام - كان قد اتخذ هناك، في تلك الغرفة، بين تلك الجدران الباقية. لم تمت حيث أُزيلت؛ ماتت حيث أصرت على البقاء.
موتها كان حدثاً يُسجّل في محاضر النقابة، ونعيًا في مركز المرأة، وفاجعةً في سجل العائلة. لكن حياتها كانت مشروعًا مفتوح المصدر، لا ينتهي بإغلاق الملف. يُوزَّع إرثها عبر ثلاثة مستودعات حيّة: الأول يحوي الجيل من المحاميات اللواتي وجّهتهن، اللواتي لا يعملن "مثلها"، بل يعملن باستخدام منهجيتها: القانون كأداة قاطعة، والمكان كحصن شخصي، والصمت كعدو يجب اجتثاثه.
أما المستودع الثاني يحفظ المؤسسات التي ساهمت في بنائها، لا كمجرد مبانٍ، بل كواجهات تشغيلية قابلة للتحديث لفكرة العدالة نفسها. فيما يختزن الثالث الفكرة الأكثر تجريداً وقوة: أن "الضمير القانوني" ليس مجرد شعور أخلاقي، بل هو موقع تشغيلي داخل النظام. موقع ثابت تقف فيه، وتراقب، وتُشير بإصبع لا ترفع إلى التناقضات، وترفض - فوق كل شيء - المغادرة.
قالت زميلة لها: "لم تكن مجرد محامية، بل كانت ضمير القانون في غزة". في إشارةٍ إلى قوة موقعها في برنامجٍ محمل على نظام يعاني من أعطال مزمنة.
لم تكافح إصلاح حسنية من أجل "العدالة" كمفهوم مجرد. لقد اختبرت، طوال 77 عامًا، حدودَ المرونة البنيوية للنظم التي تحكم البشر: النظام القانوني، النظام الاجتماعي الذكوري، نظام الاحتلال، نظام الحصار.
كانت ملاحظتها النهائية هي الأكثر قسوة: أن أقسى هذه الأنظمة ليس الاحتلال العسكري، بل نظام النزوح. النزوح من المكان، من المهنة، من الجسد، من الذاكرة. فيما هي رفضت الخضوع لأي منهم.
توفيت كما عاشت: بشروطها وحدها، لم تُستَلَب. وبقي إرثها ليس كماضٍ يُذكر، بل هو دليل استكشاف أعطال حي، مُعدّ لكل من يحاول إقلاع آلة العدالة في بيئة معادية. الدليل مفتوح. النسخة التالية متروكة لمن يجرؤ على القراءة، والتطبيق، والتحديث.