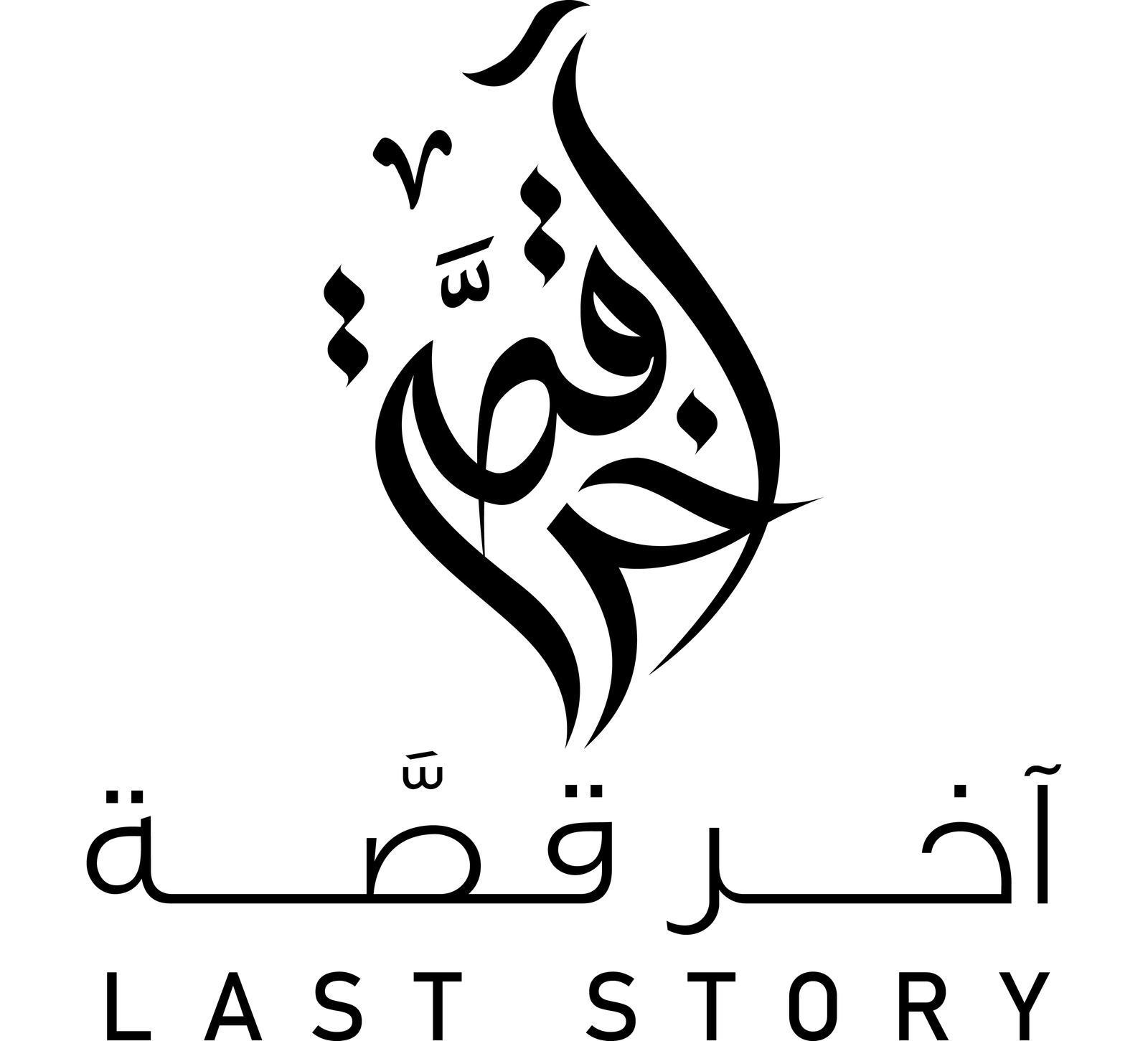في العامِ الثاني بعد القيامةِ الصغرى
افتتحوا متحفًا جديدًا قرب البحر
يعرضون فيه الذاكرة، بعد ان تخلصوا من أصحابها، الدخول مجاني، والخروج مستحيل.
في الواجهة لافتة مهترئة كقلوبنا:
"متحف الغبار".
عند المدخل، يقف رجل ببدلة رمادية يوزع كمامات، فرائحة الحقيقة خانقة جدًا.
يهمس لي وهو يناولني الكمامة: “لا تنسَ أن تبتسم في القاعة الثالثة، هناك كاميرات توثق تعاطف الزوار”.
كانت القاعاتُ بيضاءَ كعظامٍ مغسولةٍ بالحسرة، تُعرضُ الشظايا على طاولاتٍ من الزجاج، تحتَ مصابيحَ لم تجرب الضحك، وفي إحدى الزوايا، بقايا لافتةٍ نصف محترقةٍ تقول:
“مدرسة بنات الدرج الابتدائية”.
وتحتها… دفتر رسمٍ لطفلةٍ كانت تحلمُ بسماءٍ ورديةٍ وممحاةٍ على شكلِ قلب.
قال المرشدُ الأجنبيُّ وهو يُشير بعصاه المعدنية:
هنا نرى كيف كانت اللغة تموت ببطء.
لاحظوا تفتت الضمائر، واحتراق الفعل الماضي.
لا تلمسوا الرماد، إنه حي!
في القاعة الأولى،
رفات أبنيةٍ، كلّ حجرٍ يحمل رقمًا، كما لو كان جنديًا قُتل في عطلة نهاية الأسبوع. على الجدران صورٌ معلقة لطفولةٍ لم تكتمل، طفلٌ يركض نحو بابٍ مفتوحٍ على العدم، وآخرُ يضحكُ في منتصفِ الصرخة.
المُرشدُ يشرحُ بصوتٍ ثابتٍ كصوتِ موظفِ الجمارك:
"هكذا كانت الحياة هنا، لاحظوا الانسجام بين لون الركام وظلال الموتى. الفنّانون المحليون استخدموا أجسادهم كمواد أولية”.
يصفق الزوار،
الدموع تُباع في القاعة المجاورة مع البطاقات التذكارية
في الخارج، كان الزوار يلتقطون الصورَ مع الركام،
يبتسمون،
ثم يكتبون على بطاقاتٍ صغيرة: “تجربةٌ إنسانيةٌ مذهلة”.
لم يعلم أحد، أن كل ذرة غبارٍ هناك، تحفظُ اسمًا لم يُنطَق بعد، وصوتَ طفلٍ لم يصرخ، وقصيدةً توقّفَت في منتصف الشطر.
في القاعة الثانية،
نجدُ قفلاً كبيرًا مُعلقًا على بابٍ بلا جدار، يقولون إنه آخر بابٍ فُتح في مدينةٍ اسمها غزة، كل من مر تحته فقدَ ذاكرته وسريره وأمه.
تحت الباب نقشٌ من رماد:
“أمي كانت تمر من هنا، حاملةً الغيم في منديلها،
كي لا تبتل الشمس بالعطش”.
لم يصدق أحد هذه الجملة،
لكنّها صارت شعار المتحف.
في القاعة الثالثة،
تُعرض اللغة على سريرٍ معدنيٍّ بارد، اللغة التي ماتت واقفةً في طوابير الخبز، أفعالها محترقة، حروفها مبتورة، أسماؤها تبكي من الوحدة.
قال المرشد:
“هذه كانت لغة الحب نُقلت إلينا من تحت الأنقاض.
نرجو عدم لمسها، إنها هشة كذاكرة أم فقدت أولادها"
وفي الزاوية،
شاعرٌ عجوز يكتب على جدارٍ أسود،،
“حين توقف القصف، توقف الوزن أيضًا".
ضحك أحد الزوار، فصفق له الجميع.
المأساة هنا فن مفاهيمي
في القاعة الرابعة،
المرايا تهمس، كلّ مرآة تعكس وجهًا فقد صوته. أرى أمي في مرآةٍ مكسورة، تجمع الغبار في كفيها كمن تجمع نجوماً سقطت سهواً من سماءٍ خامدة.
تقول لي:
"فش داعي تعيط يما، كل شي رح يتكنس متل العادة"
وأصدقها، لأن الأمهات في غزة يَعرفنَ كيف يُربين الرماد ليصير مارشميلو.
من بعيد،
امرأةٌ بثوبٍ أسود تجمعُ الغبار في قارورةٍ صغيرة.
تقولُ للحارس: هذا ابني، بدي أخدو معي ع الدار".
لكنّ الحارسَ يبتسمُ بلطفٍ ويقولُ:
"آسف سيّدتي، هذا جزءٌ من المعروضات، وهو ملك المعرض".
في نهاية المعرض،
تُعرض مرآةٌ مكسورة. تنظرُ إليها ترى وجهك مغطّى بغبارٍ رماديٍّ ناعم،
وتدركُ أنكَ قطعةٌ من هذا المتحف.
أمشي نحو الباب،
أخلع الكمامة،
أتنفس الرماد،
أضحك مثل مجنونٍ يعرف أن نهايته قريبة،
وأهمس للعالم:
أيها العالم العاهر الذي يعيشُ منذ عامين على أنفاسِ مدينةٍ تحولت إلى لغةٍ رماديةٍ لا يفهمها أحد.
وفي الركن الأخير من المتحف،
جدارٌ طويل كعمر النسيان مكتوب عليه:
“هنا توقّف التاريخ،
لأن الضمير العالمي لم يفهم معنى كلمة،
كفى”.